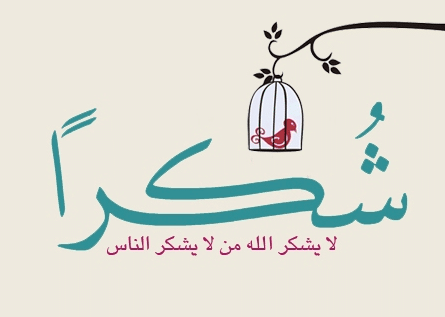بقلم: أيوب بولعيون
إن ما يُوحِّد البشر شعوبا وأمما و قبائل وجماعات تحت راية العيش المشترك، هو إحساسهم بالحاجة و الفقر(يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله و الله هو الغني الحميد )-سورة فاطر-، فكل إنسان على وجه المعمورة يشعر ذاتيا بالنقص، وهذا لا يتمخض أبدا إلا بمصارحة الذات و التصالح مع طبيعتها وحقيقتها الأصيلة، وهو ما يقتضي بدهيا التعبير الصادق عن الشكر والامتنان بمنطلق الفطرة السوية، إزاء كل معروف و فضل من “الآخر”، سواءا كان واجبا إنسانيا أو تطوعا وإحسانا، فالواجب أيضا يُشكر عليه، عكس الثقافة السائدة التي نخرت عقولنا، المختزلة في عبارة “لا شكر على واجب”! الجاهزة، المُعلقة على الألسُن، كآية منزلة من السماء، أما آدعاء الاستغناء و التغني بكمال زائف، فهو وهم كبير يعشش العقول، وتعبير صريح عن الجهل و حالة من اللاوعي والعمى، تؤول إلى حداد مع الذات و الدخول معها في خصام وصراع نفسي، ما يمنع من تحصيل” نضج انفعالي” وشخصية متوازنة، دون إغفال الانعكاسات على الجانب الاجتماعي و الحياة اليومية للفرد من سلوكات شاذة وهيمنة الاعتبارات الأنانية على التعاون الاجتماعي.
إن لتقديم الشكر دور في توطيد أواصر المحبة والأخوة بين الناس جميعا، باختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم و مراتبهم و جغرافيتهم (البادية / الحاضرة والخدمة المتبادلة بلغة المتنبي الشعرية)، فهو جسر لاستمرار التواصل والعطاء و تمتين للعلاقات الاجتماعية الحقيقية، وبناء مجتمع متماسك متعاون بين أفراده، فالشكر إذن أسلوب من أساليب التواصل السليم والفعال مع الآخرين، وعلامة من علامات “الذكاء الإجتماعي”عند الفرد، شرط أن يكون بكيفية تحفظ جوهره؛ أي دون ابتذاله، وممارسته بشكل روتيني آلي مُفرغ من معناه، فالشكر أصبح عندنا مجرد “عنوان” فقط و شعار ، وعبارة “شكرا” محفوظة، نرددها كنشيد دون الوقوف على “محتوى” الشكر و الامتنان و فضل” الآخر “و كرمه، إنما الشكر الحقيقي و المطلوب بين بني آدم، هو شكرٌ واعٍ بالهدية، بجمالية النعمة و العطية، وإظهار الشاكر لمشاعر السعادة والفرح، المبثوثة في القلب، ما يثير إحساسا بالراحة والاطمئنان عند المشكور، فالشكر بهذا المعنى ممارسة واعية و ذو طابع ” فردي” خالص يعطي للأشياء و الأشخاص قيمتهم الحقيقية.
بالعودة إلى دين الإسلام الحنيف، كمرجع للأخلاق و مصدر للتشريع الرباني، نجد للشكر حضور قوي و أهمية بالغة جدا، فَيُروى عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث صحيح يؤسس به هذا الُخلق الكريم و الطبع السليم، قوله عليه السلام (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)، حديث كباقي أحاديث النبي قليل الكلمات، عميق المعنى وكثير الدلالات، وهو المبعوث بجوامع الكلم. استنادا للحديث يتبين جليا أن نعم الله موسوطة، بما فيها نعمة الحياة كأعظم النعم، وشكر الناس هو طريق لشكر الله تعالى، أما الكفر بالإنسان هو كفر بخالقه، فالكثير منا يكتفي بشكر الله والإعراض عن الناس، وهو ما يعكس “جهلا مكدسا” وإيمانا مزيفا و مفارقة عجيبة يعيشها الإنسان في دائرة مغلقة على نفسه، يقول رب العزة في كتابه المبين (و إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار) – سورة إبراهيم-.
إن الكفور الجَحود، الضيق الأفق، ليس بمقدوره أن يغير مسار الكواكب و لا حركة الشمس و النهار ، فهو المغترب بنسيان نفسه، مصداقا لقوله جل علاه (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) -سورة الحشر- ، وهو الظالم لحقيقة نفسه، الميالة بفطرتها للامتنان لمعروف الآخرين ( و ما ظلمونا و لكن كانوا أنفسهم يظلمون)-سورة البقرة-. وفي سورة العاديات ( إن الإنسان لربه لكنود)
في جوف الشاكر تسكن روح الفيلسوف، الباحث عن نفسه في الآخرين، الملتفت دوما دون ملل و كلل إلى تجليات الوجود الإنساني، وما يرتبط به من قيم و أخلاق وسلوكيات ومواقف نبيلة حميدة تستدعي الاعتراف بصيغته الفريدة، دون ابتذاله بعقلية “المألوف و المعتاد” العقيمة، الفيلسوف الذي يسعى باستمرار لمعرفة نفسه ( ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه) -سورة لقمان -، وموقعه بالنسبة للآخر و للعالم، بعين متفحصة ثاقبة، تستشف المعاني و تستقطر الحكم، و ترفع ستار الجهل بإعادة التفكير وطرح السؤال. فهو إذن إنسان بإيمان حقيقي، يجلب له الرضا و الراحة و السكينة، أما الجاحد المتعجرف، ضحية “الأنا”/الذات الوهمية، فهو الحزين الساخط دائما، المتكبر على الآخرين بادعاءات فارغة يحاول إقناع نفسه بها ، الشقي الحائر الذي آثر الخسران على الربح و الغنى، لقوله تعالى ( لئن شكرتم لأزيدنكم). – سورة إبراهيم.-
لا شك أن للتربية الأولى التي يتلقاها الإنسان في صغره دور كبير في ترسيخ الطباع، خصوصا داخل مؤسسة الأسرة، باعتبارها الحضن والنبع الأول للأطفال، ولها الدور المحوري في تشكيل الشخصية ككل متكامل في تعاملها مع الآخرين والحياة عموما، فالطريقة التي يتلقى بها الطفل مشاعر الامتنان من والديه في بواكير حياته، تنعكس عليه و على أسلوبه و تواصله مع ذاته بدرجة أولى، ثم مع الوسط الخارجي، فهو بهذه الفلسفة يشعر دائما بالامتلاء و الرضا، يعبر بتلقائية دون تصنع عن الشكر مقابل الإحسان و الأيادي السخية البيضاء كسبيل لعيش حياة هنيئة صحية بشكل أفقي مع الناس جميعا، وهو ما يُعين الإنسان كذلك على تحقيق الذات بالتكيف النفسي و التوافق الاجتماعي و تقدير الحياة بكل نعمها الظاهرة و الباطنة.
يجب على الأسرة قبل أي مؤسسة أخرى، أن تعي جيدا أهميتها بالنسبة للنشء، أن تسعى لغرس القيم النبيلة والطباع السليمة عبر التربية بالقدوة و النموذج، ولنا في الدين الإسلامي المرجع و الكتاب والسيرة النبوية الشريفة.